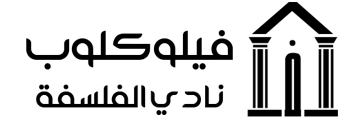منهجية القولة الفلسفية المرفقة بمطلب نموذج تطبيقي – ذ. منير عفاسي

محاور الدرس:
- المطالب والخطوات المنهجية
- النموذج التطبيقي: “العدالة هي المساواة” انطلاقا من القولة أوضح (ي) إلى أي حد يمكن أن تحقق المساواة العدالة.
المطالب والخطوات المنهجية
1 – مطلب الفهم: 04 نقط
تحديد موضوع القولة (01 نقطة)
صياغة الاشكال (02 نقط)
صياغة الاسئلة الاساسية (01 نقطة)
2 – مطلب التحليل: 05 نقط
تحديد الأطروحة القولة وشرحها (02 نقط)
تحديد مفاهيم القولة و بيان العلاقات بينها (02 نقط)
تحليل الحجاج المفترض او المعتمد (01نقطة).
3 – مطلب المناقشة: 05 نقط
التساؤل حول اهمية الاطروحة بإبراز قيمتها وحدودها (03 نقط)
فتح امكانات اخرى للتفكير في الاشكال الذي تثيره القولة (02 نقط)
4 – مطلب التركيب : 03 نقط
خلاصة التحليل والمناقشة (02)
الرأي الشخصي المبني(01 نقطة)
الجوانب الشكلية: 03 نقط
تماسك العرض 01
سلامة اللغة 01
وضوح الخط 01
النموذج التطبيقي: “العدالة هي المساواة” انطلاقا من القولة أوضح (ي) إلى أي حد يمكن أن تحقق المساواة العدالة.
ظلت المساواة دائما مطلبا و مطمحا تنادي به الشعوب و تتغنى به جل الحركات الاحتجاجية، و ترفعه كشعار ومطلب أساسي في نضالها من أجل تحقيق العدالة داخل المجتمع و تجاوز مختلف اشكال الظلم و التمييز السائدة، بشكل يبدو معه أن شرط إمكان المجتمع العادل و حجره ألاساس هو إحقاق المساواة التامة و المطلقة بين أفراده، و إلغاء مختلف اشكال التمييز و التفاوتات القائمة بحيث يغدو الناس سواسية، لكن من زاوية اخرى قد يرى البعض أن مثل هذا المطلب هو عين الظلم و الحياد عن العدالة ما دمت قدرات الناس و مؤهلاتهم متفاوتة، و بالتالي من غير العادل أن نساوي بين لا متساويين، هذا التعارض القائم بين اعتبار المساواة جوهر العدالة، و بين رفضها لما يمكن أن ينتج عن المساواة التامة من ظلم و حياد عن العدالة، هو ما يدفعنا للتفكير التساؤل عن:
ما العدالة؟ و هل تتحقق بالمساواة أم أن هذه الاخيرة هي انزياح عنها؟ و إذا كانت العدالة لا تقوم على أساس المساواة التامة، فهل هذا يعني ان اللامساواة المطلقة إحقاق للعدالة؟ أم أن بلوغ العدالة لا يتم إلا بالجمع بين المساواة و اللامساواة معا؟ و إذا كان الأمر على هذا المنوال في ما يجب تطبيق المساواة و في ما وجب عدم الاخذ بها كمعيار لتحقق العدل؟
بالرجوع إلى منطوق القولة نجدها تصرح بأطروحة مفادها أن “العدالة لا بد أن تقوم على أساس المساواة”، بحيث لا يمكن تحصيلها دون إلغاء مختلف أشكال التمييز والتفاوت بين الناس، مع ضرورة معاملتهم سواسية بغض النظر عن اختلافاتهم وتفاوتاتهم مهما كانت خلفيتها و مرجعيتها. فإذا كانت العدالة تعني الإلتزام بإعطاء كل ذي حق حقه وفق ما تنص عليه قوانين الدولة، فإنها لا تتحقق دون أن تكفل تلك القوانين المساواة أي أن تعامل الناس سواسية و دون أدنى تمييز بحيث تضمن التكافؤ و التماثل بينهم بغض النظر عن اختلافاتهم و تفاوتاتهم، مما يعني وجود تلازم مطلق بين تحقيق العدالة و إحقاق المساواة.
إن هذا الربط المطلق بين العدالة و المساواة يبقى مشروعا و له مبرراته على اعتبار أنه لطالما وجدت قوانين جائرة بنيت على أساس التمييز، و يكفي ان نستحضر كيف ان العبودية كانت مشرعنة بحكم قوانين في مجتمعات كثيرة على مر التاريخ، كما انه لطالما وجدت قوانين و شرائع أخرى جعلت من عدم المساواة قاعدة لها سواء كانت مبنية على اللون و العرق، او الدين و اللغة، و كذلك الجنس إذ لم يعامل فيها الناس بشكل متساوي باسم عدالة دفعها ثمنها الملايين من الناس و تجرعوا البؤس و الحرمان ، وشتى انواع الاهانة جرائها فقط لكونهم وجدوا خارج تصنيف محظوظي العدالة في عصرهم ومجتمعهم دون أن يختاروا ذلك، وربما لا تزال رقاب الكثير منا تحت رحمة مقصلة عدالة تنتقي من تنزل بسيفها على رقابهم فقط لأنهم ليسوا محظوظي النسب و الجاه، كالتمييز الذي قد يتعرض له البعض في الاحكام القضائية فترفع عن البعض لحظوتهم، وتنزل على البعض لدونيتهم، كما قد يحرم الكثيرين من ولوج مناصب يستحقونها فتغيب الكفاءة لصالح “المعرفة” بالمعنى العامي، او تغيب العدالة المجالية فيتم الاهتمام بمناطق معينة دون اخرى دون استحضار لمبدأ المساواة.
لذلك لا يمكن ان تجد العدالة ضالتها إلا بإقرارها المساواة التامة بين الناس بجعل القوانين في خدمة البشر جميعا لا في خدمة فئة بعينها و ذلك بضمان عموميتها، و تمتع جميع الناس بنفس الحقوق والواجبات بغض النظر عن كل الاختلافات القائمة بينهم كيف ما كانت طبيعتها. لكن ألا يمكن رغم كل هذا لعدالة عمياء لا تميز بهذا الشكل أن تصدر أحكامها على الجميع دون أن تتحول إلى عدالة جائرة؟ ألا يمكن كذلك لعدالة تقوم على المساواة أن تتحول إلى ظلم اتجاه فئات او حالات خاصة لا تؤخذها عمومية القوانين بعين الاعتبار؟
إن جعل العدالة مرتبطا بإحقاق المساواة يبدو مطلبا مشروعا إذ يتوجب أن يكون لكل المواطنين نفس الحقوق و الواجبات دون تمييز أمام القانون و هذا بالضبط ما تنص عليه حاليا معظم التشريعات في جل بلدان العالم مؤكدة على مبدأ المساواة أمام القانون، و يكفي ان نستحضر الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص في ديباجته على أن ” الكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية و حقوقهم المتساوية الثابتة هي إساس الحرية و العدل و السلام في العالم”، كما يقر في مادته الاولى على ” أن جميع الناس أحرار متساويين في الكرامة و الحقوق” و في المادة الثانية يقر ان “لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء “. هذا الإقرار بالمساواة رغم أنه قد يبدوا بديهيا اليوم إلا انه لم يكن دائما كذلك، فالتاريخ شاهد على أشكال مختلفة من التمييز سواء على أساس اللون او الدين او الجنس وغيرها، لذلك نجد ايميل شارتيي/الان يعتبر ان الحق هو المساواة، و قد ابتكر ضد اللامساواة، و أن القوانين العادلة هي التي يعامل فيها الناس سواسية، والحق لا يتجسد إلا داخل المساواة باعتبارها ذلك الفعل العادل الذي يعامل الناس بالتساوي بغض النظر عن التفاوتات القائمة بينهم. وهنا يتحدث ألان عن السعر العادل ويميزه عن سعر الفرصة؛ بحيث أن الأول هو المعلن داخل السوق والذي يخضع له الجميع بالتساوي، بينما الثاني هو سعر يغيب فيه التكافؤ بين الطرفين؛ كأن يكون أحدهما مخمورا والآخر واعيا، أو يكون أحدهما عالما بقيمة المنتوج والآخر جاهلا بذلك.
هكذا فالمساواة لن تتحقق حسب ألان إلا إذا عرض الباعة لكل الناس نفس السلع وبثمن موحد. ومعنى ذلك أن العدالة لن تتحقق إلا كانت القوانين الجاري بها العمل تعامل الناس بالمساواة التي هي أساس إحقاق الحق.وفي هذا الإطار يقول ألان: ” لقد ابتكر الحق ضد اللامساواة، والقوانين العادلة هي التي يكون الجميع أمامها سواسية… أما أولئك الذين يقولون أن اللامساواة هي من طبيعة الأشياء، فهم يقولون قولا بئيسا”.
لكن رغم كل هذا فإن اقرار المساواة المطلقة كركيزة للعدالة من خلال عمومية القوانين قد يتحول أحيانا الى ظلم، اذ قد توجد حالات خاصة لا تراها عدالة عمياء لا تميز بين الجميع في إصدار احكامها، فالقاضي مثلا يفترض فيه أن يتخلى عن التطبيق الحرفي للقانون لصالح اجتهاد قضائي يراعى فيه روح القانون بحيث يكون منصفا أحيانا، فلا معنى مثلا أن يطبق قانون السرقة على شخص جائع اضطر معه لأن يسرق ما يسد به رمقه بشكل مماثل لما يطبق على لص اتخذ من السرقة حرفة، كما لا معنى أن تفرض دولة ما الضرائب على مواطنيها بشكل متساوي دون مراعاة تفاوت دخلهم، مما يعني أن هنالك دائما بعض الاستثناءات التي تفترض نوعا من التمييز الايجابي تفتقده العدالة المبنية على المساواة. من ناحية أخرى يمكن القول ان المساواة و إن كانت ايجابية أمام القانون غالبا، فقد تصبح سلبية كذلك عندما يتعلق الامر بتوزيع الحقوق اذ يبدو أنه ليس من المعقول ان نمنح للأفراد نفس الحقوق دائما خصوصا عندما يتعلق الامر بتوزيع المستحقات كأن يمنح المدرس نفس العلامة لكل المتعلمين بالتساوي دون مراعاة لمستواهم و اختلاف قدراتهم و مجهوداتهم، فتصبح المساواة ظلما و جرما بدل ان تكون عدالة، كما قد تضعف روح الاجتهاد و الابتكار عند المتفوقين منهم جراء غياب الحافز، وهذا ما دفع ماكس شيلر الى رفض فكرة المساواة الى حد وصفه لها بكونها جائرة، معتبرا بأن العدالة لا تتمثل في المطالبة بالمساواة المطلقة بين الناس؛ لأنها مساواة جائرة ما دامت لا تراعي الفروق بين الأفراد فيما يخص الطبائع والمؤهلات التي يتوفرون عليها. فالعدالة يجب ان تكون منصفة بمراعاة اختلاف الناس وتمايز طبائعهم ومؤهلاتهم. ومن الظلم أن نطالب بالمساواة المطلقة بين جميع الناس؛ ذلك أن وراء هذه المطالبة بالمساواة كراهية وحقد على القيم السامية، ورغبة دفينة في خفض مستوى الأشخاص المتميزين إلى مستوى الأشخاص الذين هم في أسفل السلم. لذلك يذهب الى انه وبدلا من هذه الأخلاق العقلانية التي تنادي بالمساواة الصورية والنظرية إلى اقتراح ما أسماه بالأخلاق الموضوعية التي تأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين الناس على أرض الواقع. وهنا تكمن العدالة المنصفة التي تحافظ على القيم السامية التي يتمتع بها الأشخاص المتفوقون.
لكن رفض المساواة و تعويضه بالإنصاف كمعيار للعادلة بدوره قد يتحول ألى حيف كأن يصير مبررا للتمييز في إصدار الاحكام القضائية لصالح اشخاص او فئات لها مكانة اعتبارية او رمزية كما يحدث مع بعض كبار المسؤولين في دولة ما و بعض المشاهير..، أو تبريرا للتفاوتات الاجتماعية الصارخة بين الافراد و الطبقات الاجتماعية، بحيث تتم شرعنة الفقر و شتى أنواع الحرمان التي تعيشها فئات عريضة من الناس ، لهذا سنجد الفيلسوف الامريكي جون راولز قد حاول أن يؤسس لنظرية في العدالة تقوم على الإنصاف لكنها تأخذ بعين الاعتبار التفاوت الاجتماعي و الاقتصادي وتجعله لصالح الفئات الأقل حظا من الناحية الاجتماعية، اذ يرى بأن نظاما عادلا لابد أن يقوم على مبدأي “المساواة” و”اللامساواة” معا، اذ من حق كل الأفراد الاستفادة بالتساوي من نفس الحقوق الأساسية، ومن جهة ثانية يجب عدم وضع عوائق أمام أولئك الذين بحكم مواهبهم الطبيعية أو ظروفهم، يوجدون في وضع أحسن، شريطة أن يكون لباقي الأفراد حق الاستفادة أيضا من هذا الوضع. اذ للجميع الحق مثلا في التصويت والترشح، و الولوج الى الوظائف العمومية، و حرية التعبير و التنقل والحماية من الاعتداء، و اختيار طرق العيش و مشروعه الشخصي بحرية و غيرها من الحقوق الأساسية ..الخ، لكن مع إبقاء اللامساوة الاجتماعية والاقتصادية فيما يتعلق بالثرورة والسلطة، شريطة استفادة الأقل حظا من ثمار هذه الثروة والسلطة، بواسطة مبدأ تكافؤ الفرص في إمكانية جمع الثروة أو تبوأ المناصب، مثل عدم إقدام مسؤول على توظيف ابنه في منصب معين و انما وجب ان يعود المنصب لمن يمتلك الكفاءة، و في حالة ما وجد شخصين مؤهلين واحد له عمل سابق و الاخر عاطل يمنح للعاطل في إطار التمييز الايجابي، كما يتجلى ذلك أيضا في دولة الرعاية من خلال تقديم خدمات ومساعدات اجتماعية للفئات الهشة مثلا الدولة اليوم يتعين عليها تقديم المساعدة للفئات الهشة التي لن تجد ما تلبي حاجياتها به بعد انتشار وباء كورونا، وفرض حالة الطوارئ الصحية الاستثنائية، و عليها بالمقابل أن تفرض على الفئات الغنية المساهمة في تكلفة التدابير الوقائية والتداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة. بذلك يكون الإنصاف سعيا إلى مكافأة المجدين والمستحقين وتشجيعا للمنافسة، و مساعدة للأقل حظا ونصيبا من الفئات الفقيرة و الهشة.
حاصل القول ان محاولة الإجابة على إشكال مدى قدرة المساواة على تحقيق العدالة قد أفرز جدالا بين مناصر لها كما هو حال منطوق القولة وتصور اميل شارتيي الذي جعل من المساواة شرط إمكان العدالة، ورافض لها كما هو الامر مع ماكس شيلر الذي اعتبر المساواة جائرة، بالإضافة الى جون راولز الذي حاول ان يؤسس لنظرية في العدالة مبنية على الانصاف تأخذ بالمساواة من جهة، و تصحح انحرافات الانصاف المطلق من جهة ثانية.
و في الاخير يمكننا القول أن العدالة لا يمكن ان تتحقق بالمساواة المطلقة وحدها دون استحضار اللامساواة من خلال العمل بالإنصاف، إذ يجب أن تراعى الحالات الخاصة وكذلك مبدا الاستحقاق والكفاءة، فالمجتمع العادل هو الذي تنتفي في كل اشكال التمييز الاجتماعي، ويضمن لأفراده نفس الحقوق و الفرص من تعليم و سكن، و صحة و عمل وغيرها من الشروط الضرورية عبر تكريس المساواة، بعدها يأتي الانصاف من خلال فرض مبدأ الكفاءة و الاستحقاق، و هذا لن يتأتى إلا بعودة دولة الرعاية.
[button color=”black” size=”big” link=”https://wp.me/abSyCR-18y” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]تحميل الدرس PDF[/button]