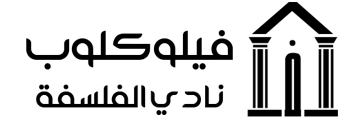القيم التربوية من منظور فلسفي – د. صابر جيدوري
أصبح من المعلوم أن القيم هي نتاج خبرات اجتماعية، تتكون نتيجة عمليات انتقاء جماعية يتفق أفراد المجتمع عليها لتنظيم العلاقات بينهم، وتكون لها من القوة والتأثير في الجماعة بحيث يصبح لها صفة الإلزام والضرورة والعمومية. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بداية هو: هل القيم نسبية ذاتية؟ بمعنى هل الإنسان هو الذي يخلق هذه القيم ويخلعها على الأشياء والمواقف؟ وهل يعني ذلك أيضًا أن قيمتها تُقدّر بمقدار ما تشبع حاجات الفرد؟ أم أنها موضوعية مطلقة موجودة في الأشياء والمواقف الخارجية ومستقلة عن وجود الإنسان؟ في الواقع هناك اتجاهات فلسفية عديدة تناقش هذه الأسئلة يمكن إجمالها في اتجاهين رئيسيين:
الاتجاه الأول:
تُعبّر عنه الفلسفات المثالية والعقلية، إذ يرى “أفلاطون” أن القيم موضوعية ومطلقة، ويؤكد على وجود عالمين متباينين: عالم المثل وعالم الواقع، وأن القيم المنبثقة من عالم المُثل هي القيم السائدة. وقد بين ذلك في كثير من محاوراته، مثل محاورة “تارميوس” حيث حلل فيها قيمة العفة وقيمة الاعتدال. وفي محاورة “ليسيس” قام بتحليل قيمة الشجاعة. وفي محاورة “بارميندس” يقول: إذا ما سلمنا بوجود عالم المُثل استطعنا بسهولة أن نقرر أن الكائن الحي واحد لإسهامه في مثال الوحدة، وكثير لإسهامه في مثال الكثرة، فكل ما هو موجود في عالم المثل هو الصدق والكمال، وكل ما هو موجود في خبرة الإنسان هو النقيض.
الاتجاه الثاني:
تُعبّر عنه الفلسفات الطبيعية التي ترى أن القيم جزء لا يتجزأ من الواقع الموضوعي للحياة والخبرة الإنسانية، فالأشياء لا ترتبط بقيم سامية لسر كامن فيها، وإنما قيم الأشياء هي نتاج اتصالنا بها، وتفاعلنا معها، وسعينا إليها، وتكوين رغباتنا واتجاهاتنا نحوها. فالقيم هي نسيج الخبرة الإنسانية وجزء لا يتجزأ من كيانها، فالأشياء ليست في ذاتها خبرة أو شريرة، صحيحة أو خاطئة، قبيحة أو جميلة. وإنما هي الأحكام التي نصدرها من واقع تأثيرنا في هذه الأشياء ذاتها.
من هذا المنطلق، يرد أصحاب هذا الاتجاه القيم إلى الواقع الاجتماعي في إطاره الثقافي، وهذا ما يؤكد ارتكازه على أسس علمية وليس على أسس معيارية، بعبارة أخرى، إن هذا الاتجاه يرد القيم إلى المجتمع وإلى التجربة، ومن ثم فهي نسبية تتغير بتغير الظروف والأحوال، فليس هناك خير مطلق ولا شر مطلق، بل يوجد مواقف عديدة كل موقف منها يتسم بخيرية أو شرية لا تتشابه مع الموقف الآخر. وعليه تُصبح الخبرة والممارسة أساس تكوين القيم، وأن دعوى أصحاب الاتجاهات الميتافيزيقية في مطلقية القيم دعوى تعسفية، إذ إن أخص خصائص الحياة الاجتماعية أنها متجددة متغيرة (ديوي، 1954).
من هذه الأرضية الفلسفية انطلق فلاسفة التربية المعاصرة في مناقشة الثنائية التي تتصل بنظرية القيم وتحليلها، ولعل من المفيد قبل الدخول في ماهية ما يترتب على موضوع الثنائية في ميدان القيم من الناحية التربوية، الإشارة إلى أن المشكلات الأساسية التي تؤرق القائمين على وضع الخطط والسياسات التربوية هي المشكلات التي تنطوي على مسائل القيمة، لأن كل القرارات التي يتخذها المفكر التربوي تكاد تكون منطوية على مسائل القيمة، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. وهذا يعني أن التربية معنية بشكل مباشر بموضوع القيم الذي يتصل بكثير من النقاط مثل: الأهداف والطرائق والسياسات التربوية مثلًا، فضلًا عن أن يبان الإنسان لأهدافه التربوية هو في الوقت ذاته بيان لقيمه التربوية.
إن الثنائية الموجودة في ميدان القيم التربوية غالبًا ما تسبب إرباكًا لواضع السياسة التعليمية، فالقائم على شؤون التربية لا بد وأن يكون في حالة اختيار دائم بين هذا النظام التربوي وذاك، أو بين هذه الطريقة التربوية أو تلك، وعليه أن يعتمد منذ البدء مجموعة متناسقة من النظم، أي فلسفة تربوية يقرر في ضوئها تفصيلات الطريقة والتطبيق. وهنا يكون عليه أن يختار بين أكثر من وجهة نظر تقع فيما بين نظم التربية التقدمية من طرف وأشكال التربية التقليدية من طرف آخر. على أن يبقى السؤال المتصل بالقيم التربوية حاضراً في ذهنه وهو: هل القيم التربوية ذاتية أم موضوعية؟
القيم التربوية بين الذاتية والموضوعية:
يذهب بعض فلاسفة التربية المعاصرة إلى أن هناك اتفاقًا في كل مجتمع حول كثير من القيم المهمة، غير أن هناك أيضًا اتفاقًا ضيقًا فيما يخص الاستفسارات الرئيسة والأساسية حول ماهية القيم بشكل عام، والقيم التربوية بشكل خاص. وهنا يبرز السؤال الآتي: هل توجد القيم التربوية مستقلة عمن يُقوّم؟ أم تكون أصولها موجودة فيه؟ أي في الشخص الذي يقوم بعملية التقييم.
إن هذا السؤال هو أحد الأسئلة التي تفجر مشكلة الثنائية في ميدان القيم التربوية، وهو من الأسئلة المهمة التي تحتاج إلى إجابة إذا أردنا أن نُسهم في تكوين نظرية واعية عن القيم. وبالرغم من تعدد الفلسفات التربوية واختلافها فيما يتصل بتقديم إجابة عن السؤال المثار، فقد برز اتجاهان أساسيان هما:
الاتجاه الأول:
تُعبر عنه الفلسفة الوجودية، ويذهب أنصاره إلى القول: إن القيم التربوية داخلية وذاتية، وكل ما تستطيع الكتب المدرسية والمناهج والمختبرات والألعاب الرياضية ادعاءه من قيمة لها هو أنها تُلبي رغبات التلميذ أو تشبع حاجاته، وبما أنه لا يوجد لهذه الوسائل قيمة داخلية أصيلة خاصة بها، فإنها لذلك ليست سوى أشياء نُقيمها، أي أنها قابلة لأن تُمنح قيمة ما. وعليه فإن المعلم أو التلميذ إذا خص أيًا منها بقيمة ما، فإنه في الحقيقة إنما يضفي عليها شيئًا من مشاعره. ولهذا السبب لا يكون المحيط من الناحية التربوية ذا قيمة بحد ذاته، ولا يكون عديم القيمة إلا إذا كان الإنسان في صلة معه. وعندما تواجه الإنسان مشكلة فإن الغريزة والعاطفة والعقل تجتمع كلها فورًا لتُعبّر عما يفضله الإنسان. وهكذا تتحقق القيمة في تلك الجهود التي يبذلها الشخص لإعادة التوازن.
ولذا تؤكد الوجودية على أن التربية يجب أن تُركز على تنمية القيم الذاتية، ويجب أن تُعامل الفرد تعاملًا خاصًا حسب نظامه القيمي، وعليه فإن الوجودي يعطي مكانة متميزة للقيم الذاتية في المنهج، فالمادة الدراسية المهمة في النظرة الوجودية هي التي يحقق من خلالها الفرد قيمه الذاتية، فالوجودي يرى التاريخ – مثلًا – في إطار صراع الإنسان لتحقيق قيمه الذاتية وأهمها قيمة الحرية، ولأن الوعي بوصفه قيمة ذاتية هو الوجود الحقيقي للطبيعة الإنسانية، فلا بد أن تعمل التربية على تنمية الوعي بحيث تُصبح غايتها خلق الفرد الواعي، وحتى يتحقق ذلك لا بد من اهتمام التربية بتحرير عقل الإنسان من الفوضى التي تحول دون رؤيته لمواقفه وإمكانيته (ماكوري، 1986).
من هنا، فإن التأكيد الشديد على القيم التي تتصل بذاتية الفرد – الحرية مثلًا – أصبحت الهدف الغائي لفلسفات التربية التي تأخذ بهذا الاتجاه، لذا فإن الفلسفة الوجودية تعيب على الفلسفات التجريبية لأنها ركزت على القيم الموضوعية ذات الطابع الاجتماعي، مما أدى إلى وجود نظام تربوي يحث التلميذ على أن يكيف نفسه مع المجتمع الذي يعيش فيه، بدلاً من أن يهتم بتحقيق قيمه الذاتية بعيدًا عن المؤثرات والضغوط الاجتماعية التي تفقده ذاته.
وبما أن مفهوم القيم يكمن في (الذات الإنسانية)، فإن أنصار هذا الاتجاه يشيرون إلى أن ذلك يستلزم من الناشئة الاستعانة بالمعرفة المتصلة بالحقائق الخارجية، لكي يتوصلوا إلى تفاهم أكثر اكتمالًا مع طبائعهم الخاصة، وضمن هذا الإطار يقررون أن القيم التي لا تنبثق عن حرية وإرادة تكون عديمة الجدوى، ومن ثم يجب على المؤسسات التربوية والثقافية أن تُنمي في الناشئة القيم دون فرضها من سلطات عليا، فمهمة هذه المؤسسات مساعدة النشء على الكشف عن قيمهم وتشجيعهم على تحقيق هذه القيم، لأن المعرفة الإنسانية ليست فكرًا خالصًا أو عقلًا محضًا، وإنما هي مجموعة من المشاعر والأحاسيس والانفعالات المنبثقة من معاناة شخصية (نيللر، 1977).
وهكذا، فإن الفلسفات التي تنادي بتكريس القيم الذاتية تعتمد اعتمادًا قويًا على خبرات المتعلم الخاصة في مواجهة المواقف التي تصادفه هو، وتحاول أن تبني منهجها التربوي عليها، ولذلك ينبغي أن يتصرف الإنسان بمفرده من أجل التصدي للأزمات، بعبارة أخرى، يجب أن يُترك الإنسان دون تدخل من غيره في تحديد قيمه بأية وسيلة من الوسائل، ودون رعاية لقيم خاصة، إذ إن القيم في نظر الفلسفة الوجودية لا بد وأن تكون وليدة التصرف الشخصي، لأن الفرد هو الذي يجب أن يكشف الغطاء عنها، فلا وجود لقيم من قبل من دون تصرفات فردية.
الاتجاه الثاني:
تُعبّر عنه الفلسفات الواقعية التي تميل إلى اعتبار القيم التربوية خارجية وموضوعية، وتُنكر أن تكون القيم مجرد خبرة شخصية داخلية، لأن للقيم وجودًا واقعيًا يعادل الوجود الواقعي لأي من القوانين التي تُسمى قوانين الطبيعة. وقد جاء في نصوصهم أن لكل شيء صورة أو هدفًا، فالصانع الماهر، مثلًا، يأخذ الخشب والفولاذ ويصنع منهما المقاعد والمساند الدراسية، وهذا يعني أنه يجعل للمواد الأولية صيغة أو صورة، وهذه الصيغة أو الصورة تجعل للشيء المصنوع هدفًا أو قيمة. فالقيمة موجودة داخل الشيء وهي موضوعيًا جزء منه.
وتجدر الإشارة إلى أن أتباع هذه النظرية لا ينكرون أن تكون الرغبة الشخصية عنصرًا مهمًا في القيم التربوية، ولكنهم يدّعون أن القيمة مستقلة عن الرغبة، إنها توجد قبل الرغبة وهي تستثيرها. ويدافع أنصار هذا الاتجاه عن الفكرة التي تقول: إن القيم إذا لم تكن موجودة في العالم ككل، فإنه من الصعب القول إنها موجودة أصلاً في جزء منه هو الإنسان. ولهذا السبب يؤكدون ضرورة أن تكون القيم التربوية شيئًا أعظم من مجرد شكل من الأشكال، أو صورة من صور العمل الهادف المفضل الراجع إلى قيمة ما يقرها أو يُعبّر عنها الأشخاص الذين يشتركون في العملية التربوية (بروبيكر، 1967).
يتضح مما سبق، أن هناك فلسفتين أساسيتين للتربية فيما يتصل بموضوع القيم التربوية، وما إذا كانت ذاتية أم موضوعية، وخشية من أن يُظهر هذا الخلاف في الرأي حول موضوعية القيم أو ذاتيتها نوعًا من الجدل، فمن المفيد إبراز هذه الثنائية من خلال النظر إليها في الواقع العملي للمدرسة:
لنأخذ اللغة الفرنسية مثالاً لإيضاح أهمية التمييز الحاصل بين الرأيين، ولتكن المشكلة ما إذا كان درس الفرنسية أو أي موضوع آخر يجب أن يوضع في المنهاج ضد رغبات التلاميذ الذين يدرسونه أو لا. في هذه الحالة فإن واضع المنهاج أمام خيارين: فإذا اتبع واضع المنهاج النظرية الذاتية في القيم فسوف يكون من الصعب عليه أن يصّر على الاستمرار في وضع الفرنسية في المنهاج على الرغم من عدم اهتمام التلاميذ بها، وعدم إدراك الآباء للحاجة إليها. أما إذا سار واضع المنهاج على عكس ذلك واتبع النظرية الموضوعية في القيم، وذهب إلى أن اللغة الفرنسية لها قيمة، بصرف النظر عما إذا كان التلاميذ أو الآباء يدركون تلك القيم، فإنه يشعر عندئذ بوجود ما يبرر وضعه للفرنسية في المنهاج على الرغم من عزوف التلاميذ أو أولياء الأمور عنها.
لا شك أن كلتا النظريتين في القيم التربوية لا تخلو من الصعوبات مهما بدا أنها مقبولة، فالإصرار على أن التلاميذ يجب أن يتعلموا الفرنسية استنادًا إلى النظرية القائلة بأنه خير لهم حتى وإن كانوا هم أنفسهم لا يدركون قيمة ذلك الموضوع، هو إصرار يعارض مبدأ التشويق في التربية. أما الأخذ بالنظرية الثانية والإصرار على أن تدرس الناشئة ما يحبون فقط، وفي الوقت الذي تريد، فيبدو أنه يجعل كل القيم نسبية، وعندئذ فإن الأسئلة الآتية تفرض نفسها:
إذا سلمنا بضرورة أن تصبح كل القيم نسبية وتابعة للذوق الفردي، فما هو عندئذ مصير الاستقرار الاجتماعي؟ وماذا يصيب التربية الأخلاقية إذا لم يكن هناك طريق ثابت في تعليم ما هو خير وما هو شر؟
قبل تقديم إجابة عن هذه الأسئلة، تجدر الإشارة إلى أن بعض فلاسفة التربية المعاصرة يرون أن الحديث عن الشر يتطلب معيارًا للقيمة يُقاس الشر بصلته به، فعندما يقول الفرد: إن الموت شر، فإنه يفترض أن الحياة خيرة، وإذا عُدّت الحياة عبثًا، فقد لا يُعدّ الموت شرًا، ولكنه خلاص من المعاناة. والجهل شر على فرض أن المعرفة قيمة، ومن الممكن أن يكون لدى الفرد نظام للقيم تُعدّ المعرفة فيه تهديدًا أو شرًا، وفي هذه الحالة يكون الجهل نعمة لا شرًا. لذا يرى أنصار النزعة الإنسانية أن المستقبل يُمثل إمكانات الشر كما يمثل إمكانات الخير، وإنه كما يزيل الشر فإنه يزيل الخير كذلك.
استنادًا إلى هذا المنطق، يذهب أنصار النظرية النسبية في القيم إلى أنه ليس هناك أية قاعدة عامة بشأن الخير أو الشر، وليس هناك معيار مطلق خاص بالقيم، بل الأمر فيها عكس ذلك، وهذا يؤكد النظرة التي تقول: “لا وجود لشيء هو خير أو شر، بل التفكير هو الذي يجعله كذلك”. من هنا يرى “فينكس” عدم وجود إشكال في ظل غياب معيار للشر أو الخير، بل إنه يُرحب بالتعليم في جو تكون فيه القيم موضع فحص مستمر تبعًا لكل مدرسة، ولكل واحد من التلاميذ المنتمين إليها. وواقع الأمر بالنسبة لهذا الفيلسوف هو أن القيم التي تكون مرنة وقابلة للتغير هي وحدها التي يكون عندها من الحيوية ما يمكنها من المحافظة على البقاء في عالم يتبدل باستمرار (فينكس، 1965).
ويشير “بروبيكر” إلى أن لدى القائل بالنظرية الذاتية طريقته الخاصة في معالجة القيم الاجتماعية من أجل ألا يربي الناشئة على إغفالها، ويعتقد بأن الطالب سوف يتعلم ويجب أن يعلم أنه يعيش مع راشدين يعنيهم أمر إثبات قيمهم والمحافظة عليها، كما يعنيه هو أمر قيمه، فإن كان يتوقع من الراشدين أن يتيحوا له الفرصة ليحقق قيمه، فيجب عليه هو كذلك أن يسلك طريقًا يتمكنون هم معه من تحقيق قيمهم.
إن سير الناشئ هنا – كما يقول “بروبيكر- وفق القيم الاجتماعية للراشدين ومن غير أن يكون هو شخصيًا قد قبلها أو نادى بها، موقف يحتمل فيه أن يختلف بعض الشيء عن الموقف الذي تُعدّ فيه القيم موضوعية. فإن قلنا: إن القيم موضوعية، فإن موضوعيتها عندئذ تكون من نوع خاص، فنحن هنا في موقف لا تكون معه القيم موضوعية بالمعنى الميتافيزيقي الدال على كونها مستقلة عن الناس الذين يقوّمون، بل تكون موضوعية بالمعنى الاجتماعي الدال على أنها قيم لدى الناس الآخرين (بروبيكر، 1967).
القيم التربوية بين الذرائعية والأصلية:
يوجد انقسام آخر تعرضت له القيم كان وليد الاعتقاد بوجود قيم ثابتة لا يمكن تغييرها أو تفسيرها في ضوء الظروف المتغيرة، وهو الانقسام في القيم إلى قيم الذرائع أو الوسائل من جهة، والقيم الأصلية أو الضمنية من جهة أخرى. وقد دافع عن طرفي هذه الثنائية اتجاهان أساسيان في التربية:
الاتجاه الأول:
تُعبّر عنه الفلسفة البرجماتية التي تؤمن بالقيم الذرائعية التي يُحكم عليها أنها حسنة، لأنها صالحة من أجل شيء ما، وأن قيمتها تابعة للنتائج التي تنجم عن استعمالها من أجل الحصول على قيم أخرى. فإذا وضعنا على سبيل المثال مخططًا دراسيًا يسير عليه التلميذ، فما الموضوعات أو القيم التي يجب أن يتضمنها؟ إن الأمر هنا يعتمد في جزئه الأكبر على نوع المهنة التي يكون التلميذ قد وضعها نصب عينه، فإذا كان قراره هو أن يُصبح مهندسًا فيجب أن تكون الدراسات التي هي من نوع الرياضيات والعلوم أو ما يخطر على بال مرشده.
وهكذا، تُصبح قيمة هذه الدراسات عندئذ قيمة الذرائع أو الوسائل كما هو واضح، لأنها الأدوات أو الوسائل اللازمة لمهنة التلميذ في المستقبل. أي أنها صالحة من أجل مهنة من هذا النوع، ولكنها قد لا تكون صالحة أبدًا من أجل مهنة أخرى مثل: المحاماة أو التمثيل أو صناعة الحلوى..
ومن هنا فإن “البرجماتيون” عمومًا يشيرون إلى أنه لا يكون في وسعنا أن نقبل قضايا صورية عن الهدف الأخلاقي في التربية، وأن كل ما تمدنا به هذه القضايا إنما هو مقولات لا معنى لها، ومن ثم لا بد من إنزال القيم الأخلاقية إلى الأرض وتفسيرها بواقع أعمال التلميذ في المدرسة، وفي محاولة “جون ديوي” التأكيد على ضرورة أن تكون القيم نافعة يقول: يجب أن تُعدّ الدراسة وسيلة تنشئة يحقق بها الطفل الجانب الاجتماعي من العمل، فإذا ما تقرر ذلك، فإنها تقدم لنا معيارًا لاختبار المادة والحكم على القيمة، فإذا كان لدينا ثلاث قيم مستقلة محدودة: أحداها تختص بالمعلومات، والأخرى بالنظام، والثالثة بالثقافة، فإن هذه القيم لا بد أن ترجع إلى ثلاثة وجوه من التفسير الاجتماعي، فتكون المعلومات حقيقية أو تربوية فقط بقدر ما تنتجه من خيالات وتصورات محددة للمادة القائمة في الحياة الاجتماعية، ويُعدّ النظام حقيقيًا وتربويًا بقدر ما يمثل من رد فعل للتعلم على قوى الفرد الخاصة حتى يمكنه إخضاعها لعملية الضبط التي تقوم بها الأهداف الاجتماعية، أما الثقافة، فإذا كان لا بد وأن تكون حقيقية وتربوية وليست بريقًا ظاهريًا، فإنها يجب أن تُمثل الاتحاد الحيوي بين كل من التعليم والنظام، بعبارة أخرى يجب أن ترسم تنشئة الفرد الاجتماعية في نظرته الشاملة للحياة وفي طريقة تعامله معها (ديوي، 1966).
وهكذا، فإن القيم الثلاث إذا لم تؤد هذه الوظائف تنتفي عنها صفة القيم، فالقيم لا بد وأن تكون نافعة حتى تكون صالحة للفرد والمجتمع، لأن القيمة الصالحة هي التي تساعد الفرد على تكوين علاقة فعّالة مع العالم ومع زملائه، ذلك لأن القيم أشكال من الحق، والحق هو كل ما يثبت أنه صالح لما نعتقد فيه، وأنه صالح لسبب نقبله، فالقيم يجب أن تكون في حالة من التغير المستمر مما يتطلب من المدرس في مجتمع متغير أن لا يُعلّم القيم، وإنما عليه أن يساعد الطفل على اكتشاف القيم بنفسه.
الاتجاه الثاني:
يؤمن أصحابه (أرسطو والمعتزلة) أن القيم الأصلية أو الضمنية هي القيم التي يُحكم بصلاحها لا من أجل شيء آخر بل من أجل ذاتها، فقيمتها ليست متوقفة على قيمة موجودة خارجها أو وراءها، بل هي ضمنية وموجودة داخلها، والقيمة الأصلية أو الضمنية لأي شيء كان يمكن تحديدها بسهولة بالبحث عن وظيفته الخاصة أو عما يتميز به. فمثلا في ظل الحياة الديمقراطية لا بد أن تتوفر الفرص المتكافئة للجميع، لأن من مميزات الديمقراطية كقيمة أنها تكرس مفهوم الحرية بمختلف أبعاده.
ومن ثم فإن مهمة المجتمع تكمن في تقديم المساعدة من أجل سيادة الحرية في جميع المدارس على أن تُعطى أهمية بالغة لمنهج الدراسة التحررية في هذه المدارس حتى يتسنى ترسيخ مفهومات الديمقراطية والعدل والسلام بوصفها قيم إنسانية خيرة في ذاتها. وداخل هذا الإطار تصبح التربية التحررية وفق هذا المنهج ثقافة عقلية تدرب فيها عقلية التلميذ لا بقصد صياغتها في ضوء هدف محدد أو من أجل حرفة محددة أو من أجل دراسة بل من أجلها هي بوصفها قيمة في ذاتها. السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل يمكن أن يكون لشيء ما قيمة ذرائعية وقيمة أصلية في الوقت ذاته؟
إن القائلين بالقيم الذرائعية الذين يعدون القيم كلها ذاتية ونسبية، يشعرون بأنهم يناقضون أنفسهم عندما يقبلون فكرة أن القيم من الممكن أن تكون أصلية وموضوعية. أما القائلون: إن القيم أصلية فإنهم على أتم الاستعداد لأن يقبلوا بان يكون لشيء ما، مثل المقعد الدراسي، قيمة أصلية وقيمة ذرائعية. فمثلاً، يجوز أن يتخذ المعلم وضعًا غير رسمي بأن يجلس على منضدته وهو يشرح إحدى المسائل، فالمنضدة ليست مصنوعة لأن تكون مقعدًا، ولكن من الممكن استخدامها مقعدًا، وبالتالي تكون لها قيمة ذاتية ذرائعية جاءتها من الاستعمال، إلا أنها محتفظة بقيمتها الأصلية الموضوعية الضمنية مهما أخذ استعمالها من أوجه.
يتبين مما سبق، أن هناك فلسفتين أساسيتين للتربية فيما يتصل بموضوع القيم: الفلسفة الأولى: ينظر أصحابها إلى القيم نظرة ذاتية، وفي رأيهم أن الأشياء قيّمة تبعًا للشعور الشخصي أنها قيّمة، وعندما يفكرون باختيار قيمة ما من بين قيم متنافسة فإنهم يختارون القيمة التي من خلالها يستطيعون تحقيق أغراضهم. أما الفلسفة الثانية: ينظر أصحابها إلى القيم التربوية نظرة أكثر موضوعية. فالقيم في رأيهم أصلية وهي لا تأتي ممن يستعملها بل من مصممها أو صانعها. غير أن أصحاب هذا الاتجاه لا ينكرون القيم الذرائعية، ولكنهم يلحون على أن القيم الذرائعية يجب أن تكون تابعة للقيم الأصلية، لأن القيم الأصلية أولية في الزمن، لذلك يغلب عليها أن تكون ثابتة ودائمة.
ولكن السؤال المهم هو: هل يوجد تطابق ولو إلى حد ما بين هاتين الفلسفتين؟ وكيف يمكن تجاوز هذه الثنائية؟
في الإجابة عن هذا السؤال يجب تحقيق شرط أساسي لذلك هو أن ننظر إلى القيم نظرة تكاملية، على أن الأخذ بهذه النظرة يجب ألا يؤدي إلى استبدال قيم بقيم أخرى، بل النظر إلى القيم سواء أكانت مثالية أم واقعية، ذاتية أم موضوعية نظرة تكاملية يترتب عليها في المقام الأول توجيه جديد عند النظر إلى النظرية العامة في القيم. كما يترتب عليها أن ينظر القائمون على شؤون التربية نظرة جديدة إلى أهمية القيم في عمل المدرسة، بوصفها الوحدة الأساسية التي تجسد النظر التربوي، وما يقوم عليه من قيم ومبادئ.
وبما أن التربية في صورتها النظامية تقوم على قيم معينة، سواء وعى المشتغلون بالتعليم بهذه القيم أم لم يعوا، وسواء عبّرت هذه القيم عن نفسها بصورة ذاتية أم موضوعية، فإن شرطاً آخر يتبلور هو: أن تقوم التربية بتمثيل ما يختاره المجتمع من قيم بغض النظر عن كونها ذاتية أو موضوعية، وإذا ما تم ذلك فإنه يقع على عاتق التعليم ذاته أن يُعبّر عن قيم تربوية معينة تتلاءم وطبيعة المجتمع، شرط ألاّ يعتمد التعليم وهو بصدد غرس قيم تربوية معينة على نظرة سلفوية متطرفة أو نظرة عصروية متطرفة، بل عليه أن يوازن بين هذه النظرة وتلك، بحيث يخرج بنظرة جديدة تتصل بالقيم تتفق مع فلسفة المجتمع واتجاهاته وآماله.
مع التأكيد أن القضية الأساسية أمام التربية هي نوع القيم ومصدرها، ومسؤولية القائمين على تنميتها، وغير ذلك من المسائل التي ينبغي أن تكون موضع اهتمام عام، وبخاصة في المجتمعات التي تشهد تحولات كبرى في حياتها نتيجة المتغيرات التي حدثت وما زالت تحدث على المسرح العالمي. ولا شك أن المجتمع العربي تأثر بهذه المتغيرات، الأمر الذي يتطلب من القائمين على شؤون التربية العربية أن يعملوا على بناء قيم مستمدة من فلسفة المجتمع نفسه، وعلى ضوء مقوماته الأصلية، وفي ضوء مطالب التغيير وطبيعة العصر الذي بدأ يفرض نظامًا جديدًا من القيم العالمية من جراء تقليص المسافات عبر وسائل الاتصال، ومن هذه القيم الجديدة قيمة السلام الذي يطرح في مجال التربية والتعليم لتنشئة الأجيال على التعامل مع المتغيرات بإنسانية أكثر.
المراجع
– بروبيكر، جون (1967) الفلسفات الحديثة للتربية، ترجمة نعيم الرفاعي، دمشق، المطبعة التعاونية.
– ديوي، جون (1966) المبادئ الأخلاقية في التربية، ترجمة عبد الفتاح السيد هلال، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والنشر.
– ديوي، جون (1954) الخبرة والتربية، ترجمة محمد رفعت رمضان، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية.
– فينكس، فيليب (1965) فلسفة التربية، ترجمة محمد لبيب النجيحي، القاهرة، دار النهضة العربية.
– ماكوري، جون (1986) الوجودية، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع.
– نيللر، ج. ف (1977) مقدمة في فلسفة التربية، ترجمة نظمي لوقا، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية.